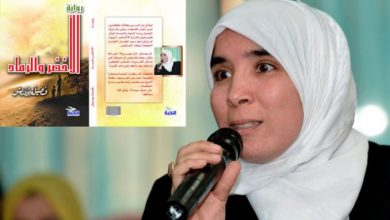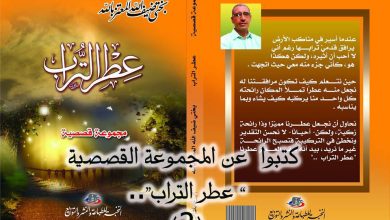نص وقضية (05)- متلازمات السرد المنتمي- من إشكالات الكتابة التاريخية إلى إشكالات التجنيس-
قراءة في نص "الصخرة الأسيرة" للصادق بن طاهر فاروق

بقلم:الناقد محمد لمين بحري
أولاً- إعلان النزوع الأسطوري من العنوان إلى النص:
يتعالق عنوان رواية الكاتب الجزائري الصادق بن طاهر فاروق* مع قصة غرائبية مأثورة، وقعت في فترة الاستعمار، وتحديداً في منطقة الجلفة، اشتهرت هذه القصة لدى العوام بقصة “الصخرة لمباصية”، أي الأسيرة.
وهي القصة التي تسردها الرواية في الصفحة 62، بهذه التفاصيل: “تعود أحداث القصة لسنة 1852، حيث إن الصخرة كانت بأعلى الجبل الكائن بالمخرج الشمالي لمدينة جلفا، وهذا هو المكان الذي يلجأ إليه الجزائريون للعمل في تكسير الصخور، ونزع الحجارة من الجبل لاستغلالها في عمليات البناء، حيث حدث أن سقطت حجرة من أعلى الجبل فقتلت أحد الضباط الفرنسيين يدعى ميشال على الفور، حيث حكموا عليها بالإعدام أولا، وخفف عليها الحكم بمعاقبتها بالأسر لمدة 35 سنة انتقاماً لما حدث للجندي الفرنسي. حيث تم تقييدها بالأغلال، ووضع أوتاد محيطة بها لكي تتم معاقبتها كل سنة مع تزامن تاريخ وموعد الحادثة، حيث يقوم الجنود الفرنسيون بإطلاق النار عليها، لما تسببت فيه من جور”[الرواية، ص62].
هكذا يعزف العنوان على قصة حادثة عرضية قام المخيال البشري (سواء لدى المستعمر أم لدى السكان المنطقة) بأسطرتها بذلك الأسلوب الذي يسمى الأنسنة؛ أي إسقاط الطبيعة الإنسانية بكل حواسها على أشياء وكائنات غير بإنسان. وبالمنطق نفسه يتغلغل العنوان الفرعي للرواية (حكاية أشباح دار البارود)، بمسافات مخيالية أكثر إغراقاً في الفانتازيا والتعجيب. إذ يعلن أن الرواية متعلقة بقصص أشباح الثورة وأطياف الأرواح التي تستمر في لعب دورها الأسطوري المألوف باعتبارها كائنات طيفية مرسلة لتنفيذ القصاص وإلحاق اللعنة بالملاعين والمعتدين (وهم في الرواية جيوش الاستعمار الفرنسي) وهذا ما تسترسل الرواية في سرده في خطية درامية متواصلة على مدى 173 صفحة.
ثانياً- هجنة النص أو المفارقات الأجناسية
1- الخطاب الأسطوري ضد الخطاب التاريخي (في الأسلبة والبناء):
يحتمل نص الصخرة الأسيرة ملمحين أسطوريين في سرد أحداثه التاريخية:
– الملمح الأسطوري الأول أسلوبي: تجنب به المؤلف طرق الأسطورة مرجعاً أو تناصاً، ما جعل السرد أسطورياً دون أصول، لكنه في المقابل لجأ إلى ما يسمى بأسطرة الوقائع والأحداث التاريخية المروية، ونسجها على نحو ميتافيزيقي ذهني يتعالى على السياقات التاريخية للأحداث وينفك منها. حيث تحل الكرامة محل الفعل البشري، وتحل الأطياف محل الذوات الفاعلة، فتتخذ المفاهيم الملحمية مثل الحرب والهزيمة والانتصار، طابعاً خوارقياً محمولا على المباركة، و اللعنة، والوعد الإلهي. مما يطبع النص في كليته بطابع قصص المآثر (Les légendes )، التي تحمل مرجعية تاريخية معروفة السياقات والأصول، لكن بأحداث وشخصيات مشحونة بالخوارق والأعاجيب والفانتاستيكية في السرد والوصف والأسلبة.
– والملمح الأسطوري الثاني بنيوي: يتصل بالتشكيل الفني في تسريد الأحداث التاريخية، التي يتجاوز بها الروائي حدود البنية الزمنية للقص، بل يقوم بنفي بينة الزمن من عالم النص، [وهذا ما يضع نسبته إلى النصوص التاريخية موضع استفهام كبير؟؟]، مستبدلاً إياها بمنطق لا زمني يضاعف الأساطيرية، ويغيِّب إحداثيات ومعالم التأطير التاريخي للأحداث، في حين يستعيض عن الزمن التاريخي للقص بعامل الوقت، (باعتباره قطعة محددة منتهية من الزمن) إذ ارتبطت جميع الخطابات والأفعال والأحداث بمجتزءات وقتية (يتداول وقوعها إما في الليل أو في النهار، أو جزء مقتطع منهما)، وتبدو هذه المواقيت كأنها أزلية ممكنة التوارد في أي زمن ومكان مثلما يخبرنا به هذا المقطع: [مع حلول الظلام بدأنا بجمع الأدوات وتنظيمها للمغادرة(…)، وفجأة انتشر صوت عالٍ لجندي مهرول نحونا: “شبح أسود يا سيدي يتحرك قرب الصخور] (الرواية ص 37). هذه الاستعاضة الفنية هي سمة السرد الأسطوري الذي عرفناه في كثير من الموروثات الأسطورية في الأدب العالمي، التي تحاول اللعب على أوقات الحكاية (الليل، النهار، الصباح، المساء)، وإهمال تحديد أوانها أو تاريخها الزمني، إشارة إلى إمكانية وقوع احداثها في أي زمن. وهو ما يسمى بالعبد اللازمني للسرد الأسطوري. وهو تحد تخييلي وفني نظراً لأن الخطاب التاريخي للسرد يشتغل على وقائع تاريخية، يفترض أنها تلزم الكاتب بالتقيد بها باعتبارها بنات شرعيات للزمن، غير أن الكاتب هنا يفي لخصوصية مخياله السردي ودلالته على حساب المرجعية التاريخية التي يشتغل عليها. ما يعني بنيوياً أن الكاتب قد خرج من ميثاق السرد التاريخي، وألقى بنصه في عهدة السرد الأسطوري، ولم يعد التاريخ لديه سوى ترفاً سردياً يتغنى به النص، لا يطابق أسلوب النص ولا بنيته الزمنية. اللذان تجاوزا السرد التاريخي واخترقاه علناً. وهذه إحدى مفارقات السرد في هذا النص الذي يتغنى بخطاب تاريخي في ظاهر التجنيس، لكنه يهدمه ويتجاوزه من حيث البناء والتأسيس.
2- المستوى الملحمي للنص- الخروج الثاني عن الزمن التاريخي:
في خروج مضاعف من الزمنية الروائية التي تسم السرد التاريخي، يهيمن الخطاب الملحمي بكل ما يحمل من ملامح لمبالغة والخوارقية للفعل والحدث، على المحكيات الضمنية للنص، وخاصة عند وصف المواقع الحربية، والمواجهات بين الجزائريين والفرنسيين التي تبدو (حروباً مقدسة)، يخوضها أبطال ميتافيزيقيون مؤيَّدون بقوى سماوية خارقة، وقدرات فائقة للإمكان البشري، تؤازرهم الآلهة، أو رسل الآلهة. في مواجهتهم للعدو الفرنسي الذي كثيراً ما توضح المشاهد انصعاقه بالقوى الخارقة والكائنات العجيبة والأطياف والأشباح، فيرتعب ويتقهقر وتخور عزيمته كما تخبرنا عديد المقاطع في النص: [يقولون إن أشباحاً يرتدون عمائم بيضاء وزياً بدوياً خالصاً يطاردون جنودنا ويقتلونهم] (الرواية ص 23).
حتى أن جنود المستعمر الفرنسي باتوا يتوجسون من أشباح الثوار التي تتربص بهم، وتثير في أنفسهم الحيرة والوساوس التي لم تعد خبيئة الأنفس، و إنما خرجت للعن فصاروا يحدثون بها بعضهم بعضاً، إذ يقول أحد الجنود متسائلاً: [فكيف أصبحوا هاجساً وكابوساً يقض مضاجعنا؟ وكيف استطاعوا أن يقيموا نسخة من الدينة في أعالي الجبال؟ (…)، لقد بتُّ أومن بما يُشاع من لعنة وكرامات (…)، خاصة وأني متيقن أن تلك اللعنة تترقبنا وتتوعدنا بالموت والعذاب إذا ما أخطأنا في حقها، ارتعدت فريصتي وانقبض قلبي، وكأن يداً خفية شدته بقوة] (الرواية، ص 106-107).
لا تجري هذه الأحاديث المسكونة بالتوجس والهلع والتصديق بالكرامات واللعنات، بين البدو أو بين السكان المحليين لمدينة الجلفة التي يحكي النص عن قصة كفاحها، وإنما بين جنود فرنسيين يحشرهم السياق الملحمي للنص في خانة الغازي المنهزم، الذي يتخبط في مأزق حروبه، ويدب في نفسه الذعر مما اقترت يداه، فيصوره النص كما لو أن لعنة ما حلت به، فسلطت عليه عدواً خفياً لينتقم منه، فلا يخرج خطابه إلا مهتزاً ومرتاباً طوال النص، يقول أحد قادة جنود الاستعمار الفرنسي في الرواية: [أنا متأكد أنهم كانوا هنا، ما زلت أرى أشباحهم تتحرك هنا وهناك (…)، كيف استطاعوا بهذه السرعة أن يرحلوا؟ كان الأمر بالنسبة لي جنونياً وشيطانياً، وراح يتسرب لي ذلك الشك الملعون، فكرت في أن يكونوا غير حقيقيين، وأنهم على الأرجح شياطين ملعونة (…) وقد فكر سيمون في ذلك وبدأ معاودة النظر فيما حُكيَ له من الكرامات ولأساطير التي يعاودها أهالي المدينة”( ).
ولا يزال القارئ يطالع الأسلوب نفسه من صفحة إلى أخرى حتى نهاية النص، وما تكرار هذا الأسلوب الفنتازي الذي ينزع إلى أسطرة أحداث الثورة ومعاركها سوى إثبات متراكم الشواهد النصية التي تقف في صف انتماء الكاتب وموقفه التخييلي المعلن المساند لطرف من أطراف حكايته، وهو ما لا يسمح لمثل هذه النصوص المتحيزة لتاريخها بكل وسائل السرد، من كتابة نص تاريخي متكامل الأركان، في سرد وقائعه، لأن التاريخ لم يعد مرجعاً في هذا النص بقدر ما صارت أسطرته الاحتفائية هي المرجع الوحيد.
ثم إن هذا النمط الثنائي للسرد: [(خير/شر)- (مقدس/ مدنس)… وطبعاً الغلبة دوماً للخير وللمقدس الذي يمثله الثوار على الشر والمدنس الذي يمثله الاستعمار كما هو معروف في أدب الأطفال وبرامجهم التعليمية والتلفزية)- لا يسمح لهذا النص من العبور إلى مقروئية الآخر قومياً وعالمياً، لأنه ينحاز عاطفياً وموقفياً وبشكل معلن إلى لون وحيد معني بالتقديس هو اللون الأبيض للثوار والآخر معني باللعنة والتدنيس هو اللون الأسود الاستعمار. ومعروف أن إظهار التحيز وإعلان المواقف والتعاطف مباشرة في السرد التاريخي يبني إيديولوجيا ولا يبني معرفة أو فناً له بعد عالمي.
ليؤكد هذا النص بأن مكانه الأثير هو الحيز الذي حددته المواقف المباشرة المعلنة فيه، ضمن دائرة محليتها المحتفلة بتخييل ملاحمها الوطنية التي تلون تاريخها الخاص بما شاءت من ألوان انتصاراتها، واحتفاءاتها الفانتازية، بتحويل الوقائع والشواهد التاريخية إلى ضرب من السرد الملحمي والأساطيري المجنح. وهذا خيار سردي لا يحق لأحد مناقشته أو انتقاده لأنه سرد له مكانته المعروفة والمألوفية في الكتابة، وإنما يتوجب وضعه في سياق هذه الكتابة المنتمية التي اختارها كاتبها، لكي لا يحسب النص على نمط آخر كالكتابة التاريخية التي تتناقض مع عواطف الاحتفاء والتحيز في احتطاب الأحداث، من مرجعيتها بعيداً عن إعلان المواقف الإيديولوجية الاحتفائية من تقديس طرف وتدنيس آخر، وكذا الأساليب والبنى الأسطورية، والملحمية التي حلت محل البنى الزمنية التاريخية وأزاحتها جانباً.
ثالثاً- رهان البطولة: (بطولة الحدث التاريخي ضد بطولة الشخصية الروائية):
هناك تصور نمطي كلاسيكي لا يزال يحكم العديد من النصوص الحديثة، وهو ذلك الرهان السردي الذي يجعل من القصة التي تهيمن فيها الشخصية حضوراً وخطاباً، على الأحداث؛ قصة شخصية، تكون فيها هذه الخيرة محورية، وجميع الأحداث المحيطة بها، أو الدائرة في فلكها، مجرد أصداء لها ورد فعل مثار عن حركتها، تكون الشخصية هي الفاعل والمؤثر، والأحداث متأثرة بها وتابعة لها، ويسمى هذا النوع من القص، بقصة الشخصية أو قصة بطولة الشخصية. أما النمط الآخر من السرد فهو ذلك الذي يسيطر فيه الحدث، ويهيمن على كل الفواعل الأخرى ومنها الشخصيات، التي تبقى كائنات تدور في فلك الحدث ومتأثرة به. وقد تمنع هيمنة الحدث في كثير من هذه القصص من بروز شخصية بطلة، لأن رهان البطولة فيها انداح للأحداث التي صارت هي الفاعل وهي البطل، بينما انمحى بفعل هذه الهيمنة، دور الشخصية وأضحت مفعولاً بها. وقد اطلق على هذا النوع من القصص بقصة الحدث أو قصة اللابطل، يبدو نص الصخرة الأسيرة من هذا الصنف الأخير. إذ لا يسلم فيه الروائي زمام البطولة وهيمنة الصوت (بما فيه صوت الراوي) لأي ة شخصية، ولا تبدو أية شخصية تسيطر على القصة سواء من الشخصيات الفرنسية أو الشخصيات الجزائرية. التي تداول صوت السارد بينها بشكل أقرب إلى الحالة الحوارية منه إلى المنظور السردي، وذلك في حالة الراوي المدمج (أي أن يكون الراوي أحد شخصيات النص)، كما تتساوى الشخصيات المتكلمة في دورها الثانوي حين يروي عنها الراوي المستقل العليم (الذي يكون صوتا فوقياً أو ذاتا ثانية للكاتب غير ممثلة بين الشخصيات).
وهكذا تبدو كل الشخصيات في النص متساوية في دورها الثانوي، حين تروي وتتحاور وتتكلم دون هيمنة لأي منها، لأن جميعها واقعة تحت سطوة الأحداث التي تحكمت في زمام السرد ومصائر الشخصيات، مما يصنف القصة تلقائياً تحت نمط قصص اللابطل. وهو نمط رائج، وخيار سردي له مقامه المستقل بين انماط السرد، وأعتقد بأن الكاتب هنا قد وفق في خيار البطولة في نصه حيث أولاه للأحداث ومجرياتها، وجسد اللابطولة بشكل يجعل سائر شخصيات الراوية المتكلمة ثانوية الأدوار ومتساوية الأصوات، الشيء الذي جعلنا نقف أمام نص حواري بامتياز، وخطاب سردي يعلو فيه صوت الحدث على صوت الشخصية. وهي خيارات سردي استراتيجية منسجمة مع نمط الحكي ووظائفه السردية.
رابعاً- أزمة السرد المنتمي- (الانصراف إلى تمجيد التاريخ، انصراف عن روائية الرواية)
من جهة أخرى جاءت سيادة الحدث وهيمنته على العالم السردي بكل فواعله في هذا النص، بصورة مبالغة في الأسطرة، كما أسلفنا، وهذا التمجيد التخييلي لأحداث التاريخ الرسمي ونفخها بالخوارق، وتحويل رجاله إلى ملائكة وأطياف، والثورة إلى حرب مقدسة محاطة بالكرامات والبركات وتأييد الإلهي، هو ما يُحَجِّم المساحة الفنية للعمل السردي، ويقوض إمكانية استقباله خارج حدود محليته الضيقة، بل ويخرجه من دائرة السرد العالمي والقومي، إلى نوع من الحكي القصصي الموجه للناشئة.
إنه نوع من السرد المنتمي فكرياً والملتزم بالانحياز بشكل مباشر ومعلن لتاريخ الأمة وتقديس منجزاتها في الأذهان، وهو ما من شأنه أن يحول الوظيفة الفنية للنص إلى وظيفة خارج نصية، ولها أن تَقرأ عربون عرفان وتكريم لشخصياتها الثورية في صورة البطل الشهيد “عاشور زيان” الذي يعتبر هذا النص ثناءً سردياً لمسيرته الثورية في مدينة الجلفة، وهي مدينة الروائي نفسه. ما يعزز الطابع الملحمي لهذا العمل الناشئ، الذي إذ نصنفه في خانة السرد التاريخي، فلأن لونه مختلف وتجريبه أسقط العديد من بنيات خطاب الرواية التاريخية المألوفة، واستعاض عنها ببدائل مغرقة في التخييل وأسلبة البنى الأسطورية، التي أمدت النص بشحنات غير متكافئة مع البنى السردية للرواية، التي بقيت معطلة بسبب الفيض العاطفي والتمجيدي الذي صبه الروائي على البنى السردية.
وما يؤثر فنياً على تلقي النص، ويقطع حبل التواصل مع المغامرة، هو إظهار المواقف المعلنة للكاتب في نص إبداعي، متحيزة للأنا ومشيطنة للآخر، وهو ما يحرم القارئ من المشاركة في رسم المسافات الجمالية الاستقبالية للنص، والتي عادة ما نجدها تثير الاختلاف بين قارئ وآخر، أو بناء أفق للتوقع، وهكذا يحرم النص من أي كسر درامي أو انتشار دلالي متعدد للأحداث، وهذا ما أخلى وفاضه من بنى التعقيد، وأفقد الحبك مهمته الأولى في تشكيل العُقد التي ألغي بناؤها حلها معاً، بسبب السرد التسلسلي المتوالي للمغامرة المحكية بخط مستقيم من ألف النص إلى يائه دون أي تعرج أو انعطاف أو تجويل في الاتجاه الذي كان لمصلحة طرف وحيد هو الدائرة الانتمائية للأنا الساردة، وضد طرف وحيد أيضاً هو الدائرة الانتمائية للآخر (الفرنسي المحتل) وشيطنته، وتبلور هزيمته منذ أول الصفحات، وهي متلازمة أسلوبية ترمي النص ومنظوره السردي في خانة التوحد، ونفي البعد الحواري الذي هو سمة جوهرية من سمات الرواية التي يدعي النص الانتساب إليها،. مما يخرج حكاية هذا مسارها من تجنيس الرواية لغياب أهم معالمها وبُناها، دون أن يخرجها من مدار السرد الأسطوري المنتمي والممجد لأناه ومحليته بنظرة أحادية لا تمنح الفرصة لأي منظور مختلف حول مصائر والأحداث والشخصيات التي تمت أسطرتها بتخييل مضاعف، ينحو منحى الخطاب التاريخي الرسمي وخطابه الذي لا يتوانى في الاحتفال بكل ما يقدس ويؤسطر وينزه رجالاته وأمجاده، ويرفع منجزاتهم إلى مصاف فعل الملائكة ويبلغ بحروبهم درجات الحروب المقدسة التي لا يليق بها سوى التمجيد الملحمي والأسطرة، وهما السمتان الأسلوبيتان اللتان تمثلان عماد الخطاب السردي في هذا النص.
*- محمد الأمين بحري
——————————–
*- رواية الصخرة الأسيرة للصادق بن طاهر فاروق الصادرة عن دار ميم للنشر 2016. الفائزة بجائزة على معاشي للإبداع 2017،