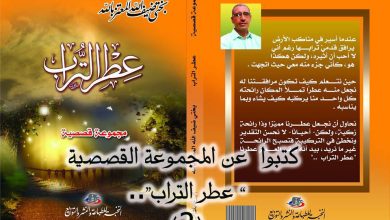الحريق الذي أشعل الرواية الجزائرية

بن علي لونيس
ثمة روايات تظل محفورة في ذاكرة القارئ، فلا تتأثّر بتبدّل الأزمنة، وهذه النّصوص هي التي تخلد، ولاتموت بموت عصرها، أومبدعها. مازلتُ متشبثاً بموقفي من أنّ رواية «الحريق» لمحمد ديب (1920 – 2003)، هي أعظم نصّ روائي جزائري، وأنا أعرف مدى مبالغتي في إصدار هذا الموقف، لكني لن أتنازل عنه. نص «الحريق» نص غير عادي، والدليل أنّ مشاهدا كثيرة منه لا تريد أن تمّحى من ذاكرتي. الرواية هي جزء من ثلاثية كتبها محمد ديب قبل اِندلاع الثورة التحريرية وأثناءها، وقد أتفق مؤرخو الأدب الجزائري على تسميتها بالثلاثية الجنوبية (الدار الكبيرة،1952)، (الحريق،1954)، (النول،1957)، جعلت الكاتب الفرنسي الكبير لويس آراغون يُطلق على ديب لقب (بلزاك الجزائر)، وقد شغلت هذه الثلاثية النقاد الجزائريين كما النقاد الفرنسيين، على غرار جان ديجو وشارل بون، هذا الأخير يعتبر أحد أهمّ المتخصصين في روايات ديب، وقد أفرد له كتبا بأكملها.
لا يمكن أن أنسى وصف هذه الثلاثية للوضع الاجتماعي للجزائريين إبان الاحتلال الفرنسي، وتحديدًا في الفترة التي شهدت بداية المدّ الوطني في وعي الجزائريين، فبعد الحرب العالمية الثانية، وأحداث08 ماي 1945 كانت البداية لشرارة العمل الثّوري في شقّه السّياسي والنّضالي، وقد جسّد محمد ديب دور المثقف المناضل من خلال مساهماته في الكتابة الصحافية، فكان قريبا من الواقع، ولعل إضراب عمال عين طاية في 1939 الذي كتب عنه نصًا في جريدة «الجزائر الجمهورية»، وهي ذاتها الجريدة التي كان يكتب فيها ألبير كامو، كان بمثابة النص – النواة لرواية الحريق.
رواية الحريق التي تصوّر اِنتفاضة فلاحي قرية بني بوبلان بأعالي تلمسان، كانت بمثابة رواية الواقعية النقدية التي لم تكتف بوصف الواقع المزري للجزائريين بسبب السياسة الاستعمارية بل منحت الصّوت والكلمة لضحايا التّاريخ لينتقدوا وضعهم، وكان ذلك تمهيدًا لنشوب الحريق العظيم الذي سيأتي على الأخضر واليابس.
سنرى تطور الوعي الوطني، في الرّواية نفسها، من خلال عيون شخصية «عمر»، وأعتقد أنّ عمر يمثّل إحدى أيقونات الشخصية الروائية في الرواية الجزائرية الحديثة، فهو الشخصية الأشهر، لأنّ ديب اِستطاع أن يختزل فيها نظرة جيل إلى الحياة وإلى الواقع في ظلّ الاستعمار، بل أنّ أسئلة عمر سواء تلك التي كان يطرحها في البيت الكبير للعائلة (دار سبيطار) أوفي المدرسة الكولونيالية أوفي الرّيف لما اِكتشف شخصية «حميد سراج» هي الأسئلة التي أيقظت في الرواية الجزائرية حسّها النّقدي، لتخلق المسافة الفنية بينها وبين الرّواية الكولونيالية، هذه الأخيرة كان جوهرها هو سلب الأصلاني صوته وقدرته على التّكلم ونقد واقعه.
بدأ كل شيء من مشهد حواري، من أنضج الحوارات الروائية وأذكاها؛ فلقاء المناضل الشّيوعي حميد سراج بفلاحي بني بوبلان، كان بداية اختبار لإمكانية الجزائري على أخذ الكلمة بحرية ومسؤولية، والانصات إلى مختلف الآراء والمواقف. هل يستطيع الفلاح أن يبني فكرة عن واقعه؟ ماحدود معرفته بالعالم الذي يعيش فيه؟ بسبب الحوار الذي جرى بين هذا المثقف الشيوعي والفلاحين اِنقشعت الكثير من الغيوم التي كانت تحجب عن الفلاحين النّظر إلى ما يحدث حولهم. تساءل أحدهم: «أيمكن أن يوجد أمثالنا من البشر من يعاني من القهر والاستعباد؟». الكثيرون لم يصدقوا لما سمعوا من سراج أنّ في فرنسا في تلك اللحظة (صيف 1939) فلاحون يعانون مثل معاناتهم، ويعملون أجراء عند غيرهم. أما الدّهشة الكبرى فكانت لما أخبرهم أنّ فرنسا في هذه اللحظة خاضعة لاستعمار دولة أخرى. أيُعقل ذلك؟ هل يمكن أن يكون هذا الرّجل قد فقد صوابه، وقد جاء من المدينة لأجل أن يسخر من أميين أمثالهم؟ أسئلة كثيرة تفجرت، أمام حقيقة بدت لهم كأنّها المستحيل: أيعقل أن تكون فرنسا التي تستعمرنا مستعمَرة؟
اِستطاع سراج من خلال الصّدمات التي كان يثيرها في نفوس الفلاحين أن يسقط من مخيلتهم صورة فرنسا التي لا تُقهر، بل بدت في الأفق فجأة علامات أمل ما، بأنّ هذا الذي نعتقد أنه لا يُهزم، ليس أكثر من كائن ضعيف لما يكون أمام إرادة أقوى منه.
اِنتهى الاجتماع بهمهات الفلاحين الذين لم يصدّقوا تماما ما كان سراج يعرضه أمامهم، لكني أنا لم أبرح مكاني فعدتُ إلى ذلك الحوار، وأكاد أشتم رائحة العشب الذي أحرقته شمس الظهيرة في ذلك المكان الذي شهد أشهر اِجتماع سياسي في تاريخ الرواية الحديثة في الجزائر، وأدركتُ أنّ ديب لم يكتب نصا عاديا، بل أنّ روايته كانت نبوءة للثورة التحريرية، فقد انتهت بحريق مهول، هو حريق الثورة القادمة.
بعد الاستقلال، دخل ديب في رؤية روائية جديدة ومختلفة من حيث الأسلوب والرؤيا، متجاوزًا المنظور الواقعي، فكان أقرب إلى الكتابة السريالية، فجاءت روايته (من يذكر البحر، 1962) التي تعرّضت إلى الآثار النفسية والروحية للحرب على الجزائري لكن بكثير من الرمزية، والصوفية. كان ديب يصف روايته بأنّها (ألف ليلة وليلة) لكنّها كُتبت بأسلوب حداثي، مصوّرا عالما أبوكالبتياً، في غاية التعقيد، حتى أنّ المؤرخ الأدبي الفرنسي جان ديجو قد وصفها بالرواية المعقّدة.
لقد دخل ديب إذن في عوالم الكتابة الداخلية، فصار أكثر اشتغالا على أسلوبه وعلى أدواته الفنية، بالإضافة إلى أنّ تجربة المنفى قد تركت آثارها على رواياته، موضوعاتيا وفنيا، فاقتربت أسئلته إلى مواجع الإنسان بغض النظر عن قوميته، إذ اِبتعد شيئا فشيئا عن الكتابة من داخل الحساسية الوطنية الضيقة مؤمنا بأنّ العالم وحده هو الوطن الذي يجمع الجميع.
في روايته الرائعة «L’Infante Maure، 1994» أو«الأميرة الموريسكية»، والتي سيصدر كتاب عنها من تأليفي عن منشورات الاختلاف بالجزائر، تطرّق ديب إلى سؤال الوطن العالمي العابر للجغرافيات القومية الضيقة، فالتصقت كتابته بوعي طفولي في نقائه الطفولة (تيمة الطفل تتكرر كثيرا في جل رواياته)، وفي حدة أسئلتها التي طرحتها الطفلة (ليلي بيل) التي هي ثمرة زيجة مختلطة بين أب جزائري وأم أوروبية (لم يحدد جنسيتها)، وهي في الشّمال البارد، كانت تسأل عن سرّ تلك الأرض الدافئ ة التي كان والدها لايتوقف عن السّفر إليها والعودة منها محملا بدفئها الغريب.
لقد تنوّعت تجارب محمد ديب الروائية تحديدًا، ومع ذلك تظلّ روايته «الحريق» هي الرواية الأشهر، والتي رفعت اِسمه عاليًا في المشهد الروائي في العالم، فقد كان يحاضر في كبريات الجامعات الأوروبية والأمريكية، وأقيمت على شرفه الكثير من الملتقيات، ومع ذلك، ماذا بقي من تراث محمد ديب اليوم؟ هو السؤال الذي أتركه مفتوحا، لكن ذلك لن يمنعني من إعادة قراءة روايته الحريق بالمتعة نفسها.
المصدر:https://www.nafhamag.com/2015/04/30/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9/